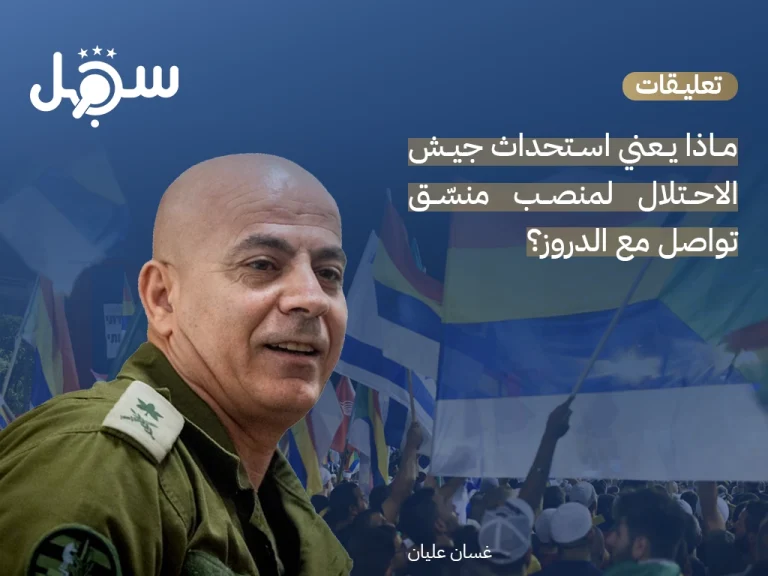محافظة القنيطرة السورية، التي تُعد الجسر الطبيعي بين سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، تمثّل قلب بلاد الشام وأحد أهم مناطقها الاستراتيجية. فموقعها يمنحها إشرافاً مباشراً على مساحات واسعة، إلى جانب ثروتها المائية التي تغذّي منابع نهر الأردن وبحيرة طبريا، وهو ما جعلها ساحة صراع دائم ومطمعًا للاحتلال الإسرائيلي.
تتألف الجغرافيا الطبيعية للمحافظة من وحدتين رئيسيتين: هضبة الجولان وجبل الشيخ.
هضبة الجولان: هضبة بازلتية تمتد على مساحة تُقدَّر بنحو 1,860 كيلومتراً مربعاً، تنحدر من سفوح جبل الشيخ شمالاً حتى نهر اليرموك جنوبًا. وبفضل تربتها البركانية الخصبة، تشتهر بزراعات نوعية مثل التفاح والكرز والقمح. يحدها من الغرب بحيرة طبريا وسهل الحولة، ومن الشرق وادي الرقاد الذي يفصلها عن سهل حوران.
جبل الشيخ: كتلة جبلية كلسية اكتسبت اسمها من الثلوج التي تكلّل قممها على مدار العام. وتصل أعلى قممها إلى 2,814 متراً فوق سطح البحر على الحدود السورية–اللبنانية، لتكون بذلك أعلى نقطة في سوريا والساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط.
تاريخياً:
اسم القنيطرة هو تصغير لكلمة قنطرة، في إشارة إلى دورها التاريخي كجسر ومعبر للقوافل التجارية والحملات العسكرية عبر العصور. وقد ارتبطت تسميتها بموقعها الجغرافي الحيوي الذي جعلها نقطة مرور طبيعية بين المشرق والساحل، وملتقى طرق يربط بين بلاد الشام وأراضي فلسطين ولبنان والأردن.
تعود أقدم الأدلة على وجود الإنسان في الجولان إلى عصور ما قبل التاريخ، حيث عُثر في موقع “بركة رام” على تمثال صغير ، ويُعد من أقدم الشواهد على محاولات النحت الرمزي، رغم الجدل العلمي حول طبيعته ووظيفته. شهدت المنطقة لاحقاً تعاقب هجرات لشعوب سامية قديمة، أبرزها العموريون والآراميون الذين أسسوا ممالك وسيطروا على أجزاء من الجولان، ولا سيما في مرحلة أرام دمشق.
وفي الفترات اللاحقة، لم يشهد الجولان استيطاناً واسعاً خلال الحقبة الهلنستية مقارنة بمناطق أخرى من بلاد الشام، لكنه دخل مرحلة ازدهار كبيرة خلال العصرين الروماني والبيزنطي، حيث توسّعت الأنشطة الزراعية والعمرانية، وأُنشئت شبكات طرق ومعالم معمارية عكست أهمية الجولان كمنطقة استراتيجية وحلقة وصل بين المراكز الحضرية الكبرى في المشرق.
بعد الفتح الإسلامي، خضعت منطقة الجولان لحكم الدولة الأموية ثم العباسية، لكنها تعرضت لتراجع سكاني ملحوظ نتيجة زلزال مدمّر ضرب المنطقة في القرن الثامن الميلادي. وفي القرون اللاحقة، اكتسبت الجولان أهمية استراتيجية بوصفها حاجزاً طبيعياً أمام تقدّم الحملات الصليبية. وقد دخلت تحت حكم الأيوبيين بقيادة صلاح الدين الأيوبي، قبل أن تنتقل إلى سيطرة المماليك عقب انتصارهم على المغول في معركة عين جالوت عام 1260.
خلال العهد العثماني، أصبحت الجولان جزءً من سنجق حوران. وبعدها في فترة الانتداب كانت هضبة الجولان ضمن حدود فلسطين لفترة وجيزة، ثم تخلت عنها بريطانيا لفرنسا في اتفاق 7 مارس 1923. أصبحت الهضبة جزءاً من سوريا عند إنهاء الانتداب الفرنسي عام 1944. وارتفع عدد السكان وتوسع العمران في الجولان بعد عام 1948 مع وصول اللاجئين الفلسطينيين.
في 27 أغسطس 1964، تم استحداث محافظة القنيطرة بموجب المرسوم التشريعي رقم 133، لتكون المحافظة السورية الرابعة عشرة. تشكلت من دمج منطقتين إداريتين: منطقة القنيطرة التي كانت تتبع لمحافظة دمشق، ومنطقة فيق التي كانت تتبع لمحافظة درعا. هذا الإجراء جاء قبل ثلاث سنوات فقط من الاحتلال وأًصبح اسم الجولان مرادفاً لمحافظة القنيطرة.
ديموغرافيا المنطقة قبل النكسة
قبل حرب يونيو/حزيران 1967، كانت محافظة القنيطرة نابضة بالحياة، وتتميّز بكثافة سكانية وتنوع عرقي وديني يعكس عمق تاريخ بلاد الشام وتداخل مكوناتها. قُدّرت أعداد السكان آنذاك بما بين 147,613 نسمة و154,000 نسمة، موزعين على تجمعات سكنية امتدت على كامل الهضبة، شملت مدينتي القنيطرة (المركز الإداري والتجاري) وفيق، إضافةً إلى أكثر من 163 قرية و108 مزرعة.
شكّلت المكونات العرقية والدينية المتعايشة في الجولان مجتمعاً سورياً مصغراً. العرب السنة هم الأغلبية فيه وأساس البنية الاجتماعية، عدد قراهم 136 قرية وانتمى الكثير منهم إلى عشائر عربية عريقة أبرزها النعيم والفضل التي امتد وجودها في الجولان وحوران لقرون طويلة.
كما استقر الشركس في الجولان أواخر القرن التاسع عشر، حوالي عام 1878، بعد تهجيرهم من القوقاز، وبدعوة من السلطات العثمانية أسسوا تجمعات قوية في 7 قرى منها المنصورة، وبيرعجم والقحطانية. وعلى غرار الشركس، استقر التركمان في الجولان أواخر القرن التاسع عشر، حوالي عام 1880، وأسسوا 14 قرية مثل العليقة والسنديانة والأحمدية.
كما شكل الدروز أقلية مهمة في المحافظة، تركز وجودهم في القرى الواقعة على سفوح جبل الشيخ وفي بعض قرى وسط الجولان. كانوا جزءاً مهماً من المجتمع ولم يكونوا يشكلوا الأغلبية قبل عام 1967، على عكس الصورة التي حاول الاحتلال الإسرائيلي ترويجها لاحقاً.فيما ضمت المحافظة أيضاً أقلية علوية، تركز وجودها في عدة قرى مثل عين فيت، الغجر وزعورة. وكذلك كان المسيحيون جزء من المجتمع.
حرب 1967 الاحتلال والتهجير الجماعي
في الأيام الأخيرة من حرب يونيو 1967، احتلت القوات الإسرائيلية ثلثي مساحة الجولان، أي ما يقارب 1200 كيلو متر مربع. أُجبر ما يزيد عن 131,000 مواطن سوري، أي أكثر من 95% من إجمالي سكان المحافظة، على النزوح من ديارهم. وحدث هذا نتيجة عمليات الطرد المباشر التي نفذها الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى انسحاب الجيش السوري والإعلان الإذاعي السوري المبكر عن سقوط مدينة القنيطرة – أعلن عن السقوط عبر راديو دمشق في الساعة 8:46 وحمل هذا البلاغ رقم 66 الصادر عن وزير الدفاع السوري آنذاك حافظ الأسد، في حين لم يدخلها الجيش الإسرائيلي إلا بعد أكثر من خمس ساعات من موعد صدور البيان – مما بث الذعر بين السكان ودفعهم إلى الفرار لإنقاذ حياتهم.

بعد تهجير غالبية سكان الجولان، شرعت سلطات الاحتلال في تنفيذ عملية تدمير ممنهجة استهدفت معظم القرى والبلدات السورية، بهدف محو أي أثر لوجودهم التاريخي في المنطقة. ففي أيار 1968، وُضعت خطة لهدم 127 قرية مهجورة، وسرعان ما نُفذت عمليات الهدم على يد مقاولين جرى التعاقد معهم خصيصًا لهذه المهمة. وتشير المصادر إلى أن ما يقارب 223 قرية ومزرعة سُويت بالأرض بالكامل.
نتيجة ذلك، تحوّل معظم سكان الجولان إلى نازحين داخل وطنهم، وتوزعوا على محافظات سورية مختلفة، مع تركّز تجمعاتهم الأكبر في دمشق وريفها (جديدة عرطوز، الكسوة، سبينة، الحجر الأسود)، إضافة إلى محافظة درعا. وتشير التقديرات الحالية إلى أن عددهم يقارب 800,000 نسمة. ورغم مرور أكثر من نصف قرن على نزوحهم، ما زالوا يحافظون على هويتهم الجولانية بتراثها وعاداتها وتقاليدها، ويتمسكون بحقهم في العودة إلى ديارهم.
البقية الباقية: خمس قرى درزية وقرية علوية
لم يتمكن سوى عدد قليل جداً من سكان الجولان من البقاء في أرضهم بعد الاحتلال الإسرائيلي عام 1967. وقد أبقت إسرائيل عليهم بشكل مقصود لخدمة أهداف سياسية تتعلق بإبراز “وجود سكاني” محدود في المنطقة المحتلة. تركز هؤلاء السكان في خمس قرى تقع في أقصى شمال الجولان عند سفوح جبل الشيخ، هي: القرى الدرزية الأربع مجدل شمس، بقعاثا، مسعدة، عين قنية، إضافة إلى قرية سحيتا التي رُحّل أهلها إلى قرية مسعدة القريبة قبل أن تُهدم بالكامل، وقرية علوية واحدة هي الغجر.
لم يكن بقاء سكان القرى الخمس في الجولان بعد عام 1967 أمراً عشوائياً، بل استثناءً مدروساً خدم الأهداف السياسية للاحتلال الإسرائيلي. فقد تبنّت الحكومة الإسرائيلية، بقيادة الوزير يغئال ألون، خطة تهدف إلى إقامة “دويلة درزية” في الجولان تكون بمثابة حليف لإسرائيل ومنطقة عازلة تفصلها عن سوريا ولبنان. ومن خلال هذا المخطط، سعت إسرائيل إلى تعميق الشرخ بين الدروز وبقية مكونات الشعب السوري، وتقديم القضية على أنها “قضية درزية” محصورة، في محاولة لعزلها عن بعدها الوطني السوري.
جاء هذا التوجه ضمن استراتيجية أوسع لتفتيت المنطقة إلى كيانات طائفية متناحرة في سوريا ولبنان، بما يضعف الجبهة العربية ويؤمن لإسرائيل حدوداً أكثر استقراراً في الشمال.
في المقابل، ساهمت عوامل خاصة بالسكان في بقائهم، أبرزها إرادة الصمود ورفض التهجير التي اكتسبوها من تجربتهم خلال الثورة السورية الكبرى عام 1925، بالإضافة إلى دور دروز الجليل والكرمل في طمأنتهم بأن إسرائيل لن تمسهم بسوء إذا تعاملوا بعقلانية مع الوضع الجديد.
تباين الواقع بين الأراضي المحررة والمحتلة
يقتصر الجزء الخاضع للإدارة السورية السابقة من المحافظة على مساحة تقدّر بحوالي 512 إلى 600 كيلومتر مربع. يقطن في هذه المنطقة عدد قليل من السكان، حيث قدر عدد السكان بحوالي 113,165 نسمة في فبراير 2022.
بعد تدمير مدينة القنيطرة، أصبحت مدينة السلام (التي أنشئت عام 1986) وبلدة خان أرنبة المجاورة المركز الإداري للمحافظة. تضم المنطقة أكثر من 40 تجمعاً سكانياً، منها قرى حضر وجباثا الخشب في سفوح جبل الشيخ وبير عجم وأم باطنة.
شهدت المنطقة عودة جزئية لبعض النازحين بعد اتفاقية فك الاشتباك عام 1974. لكنها بقيت تعاني من ضعف التنمية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة لعدة أسباب وأهمها القبضة الأمنية الشديدة التي فُرضت عليها بعد اتفاقية 1974، مما غيّبها عن الاستثمارات، و بقيت تعتمد بشكل أساسي على الزراعة وتربية المواشي.
الهضبة المحتلة:
يقدر عدد السكان السوريين المتبقين في الجولان المحتل حالياً بما يتراوح بين 23,000 و28,000 نسمة. يتركز هؤلاء السكان في القرى الدرزية (مجدل شمس، بقعاثا، مسعدة، عين قنية) والغجر
رفض غالبيتهم الجنسية الإسرائيلية. وترسخ هذا الموقف بعد أن أقر الكنيست الإسرائيلي “قانون ضم الجولان” في 14 ديسمبر 1981، رداً عليه، أصدرت قيادات المجتمع المحلي “الوثيقة الوطنية لأهل الجولان” في 25 مارس 1981، التي أصبحت دستوراً سياسياً واجتماعياً لهم. أكدت الوثيقة بشكل قاطع أن الجولان جزء لا يتجزأ من سوريا، وأن الهوية العربية السورية صفة أبدية، وفرضت مقاطعة دينية واجتماعية كاملة على كل من يقبل بالجنسية الإسرائيلية.
لهذا السبب، يحمل معظمهم اليوم صفة “مقيم دائم”، ووفقاً للإحصاءات التي أجراها المرصد – المركز العربي لحقوق الإنسان في الجولان، أقل من 10% من السكان تقدموا طواعية للحصول على الجنسية الإسرائيلية منذ عام 1967 وحتى الآن. إنهم يؤكدون باستمرار وبكافة الوسائل على أن الجولان أرض سورية محتلة، وأنهم جزء لا يتجزأ من وطنهم الأم، سوريا.
الاستيطان في الجولان:
بدأت عمليات الاستيطان الإسرائيلي في الجولان مباشرة بعد احتلالها، وأصبحت مشروعاً استراتيجياً مدعوماً من سلطات الاحتلال. نجحت من خلاله في تحقيق تكافؤ بين أعداد المستوطنين والسكان السوريين. يٌقدّر عدد المستوطنين بحسب إحصائية عام 2021 ب 29 ألفاً. يتوزع هؤلاء المستوطنون على ما بين 33 و45 مستوطنة أقيمت على أراضي القرى السورية المدمرة.
في ديسمبر 2024، وفي أعقاب التحولات السياسية الكبرى في سوريا، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة تهدف إلى مضاعفة عدد المستوطنين في الجولان، في محاولة لخلق أغلبية سكانية إسرائيلية وترسيخ واقع ميداني يعقّد أي تسوية مستقبلية تقوم على الانسحاب من الأراضي المحتلة.
وعلى الرغم من تصاعد وتيرة الاستيطان وفرض واقع ديموغرافي جديد، ظل سكان الجولان الصامدون يواجهون محاولات طمس هويتهم، متمسكين بانتمائهم لوطنهم سوريا. ولا تزال قرى الجولان حاضرة في وجدان مئات الآلاف من النازحين، الذين يورّثون أبناءهم حلم العودة وحقهم في ديارهم. أما القسم المحرر من المحافظة، فهو يمثّل اليوم ذاكرة حية للصمود، ورمزاً للأمل بعودة بقية الأرض إلى أصحابها.